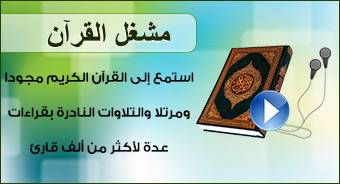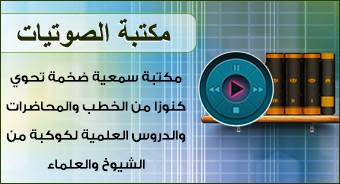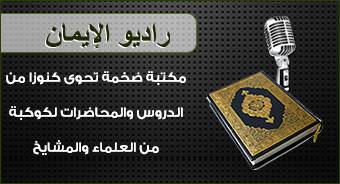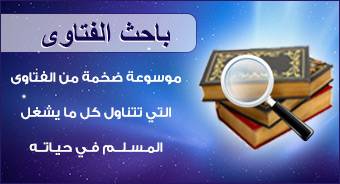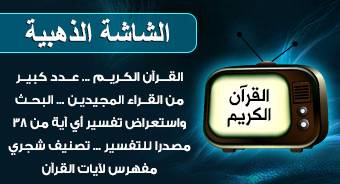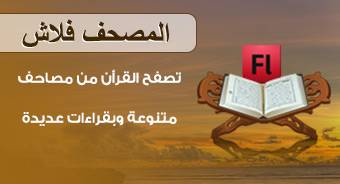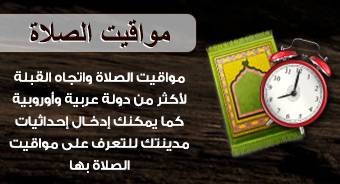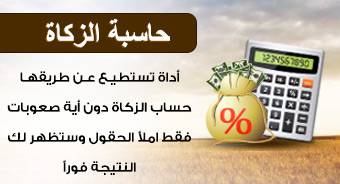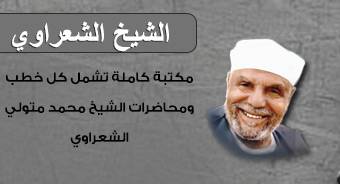|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
وهي من رجز الراجز رجزا: أنشد أرجوزة. ويقال: رجز له: أنشده أرجوزة، فهو: راجز. ورجّاز ورجّازة: والراجز: من ينشد الرجز أو يصنعه. والأرجوزة: القصيدة من بحر الرجز. والرّجز: بحر من بحور الشّعر أصل وزنه مستفعلن ست مرات. قال النسفي: الأرجوزة: كلام موزون على غير وزن الشعر. وقد رجز الراجز، من حد دخل: أي تكلم بذلك. [أساس البلاغة ص 155، والمصباح المنير 1/ 298، ومختار الصحاح ص 234، وطلبة الطلبة ص 331، والمعجم الوسيط 1/ 342].
وهو في اللغة: الصب، يقال: أراق الماء: أي صبه، والأصل الهمزة، وتبدل أيضا هاء، يقال: أرقت الماء بالفتح، فأنا أريقه بالضم، وهرقته: فأنا أهريقه بضم الهمزة. وتجيء في كتب الفقه في (الذكاة) يقولون: إراقة الدّم، وكذا تأتي في (الأشربة) يقولون: إراقة الخمر. وتجيء في (الطهارة): إراقة الماء على البول لتطهير الأرض، وفي الحديث: «وهريقوا على بوله سجلا من ماء». [أخرجه البخاري في الوضوء (58)] والأصل هريقه وزان دحرجه، ولهذا تفتح الهاء من المضارع، فيقال: يهريقه كما تفتح الدّال من يدحرجه، وتفتح من الفاعل والمفعول أيضا، فيقال: مهريق ومهراق. قال امرؤ القيس: والأمر هرق ماءك، والأصل هريقه، وزان دحرج، وقد يجمع بين الهاء والهمزة، فيقال: إهراقه يهرقه ساكن الهاء تشبيها له باستطاع يستطيع كأن الهمزة زيدت عوضا عن حركة الياء في الأصل، ولهذا لا يصير الفعل بهذه الزّيادة خماسيّا. (دعا بذنوب فأهرق): ساكن الهاء، وفي (التهذيب) من قال: أهرقت، فهو خطأ في القياس، ومنهم من يجعل الهاء كالأصل، ويقول: هرقته هرقا من باب نفع. وفي الحديث: «إنّ امرأة كانت تهراق الدّماء». [أخرجه أحمد (6/ 293)] بالبناء للمفعول، والدّماء: نصب على التمييز، ويجوز الرفع على إسناد الفعل إليها، والأصل تهراق دماءها، لكن جعلت الألف واللام بدلا عن الإضافة، كقوله تعالى: {عُقْدَةَ النِّكاحِ} [سورة البقرة: الآية 237]: أي نكاحها. [مشارق الأنوار 1/ 27، والمصباح المنير 1/ 338، 339، والموسوعة الفقهية 3/ 6].
وأراك فلان الإبل: أرعاها الأراك. والأراك: هو شجر المسواك، واحدته أراكة، وهو: نبات شجيرى من الفصيلة الأراكية كثير الفروع والورق، ناعمة شجرته خوار العود، متقابل الأوراق، له ثمار حمر دكناء في عناقيد وهي تؤكل، ينبت في البلاد الحارة، ويوجد في صحراء مصر الجنوبية والشرقية، وثمرة يسمّى البرير، ويملأ عنقوده الكفّ. قال المناوي وغيره: محل بعرفة من ناحية الشام. [أساس البلاغة ص 5، والمصباح المنير 1/ 17، ومختار الصحاح 1/ 14، والمعجم الوسيط 1/ 15، والتوقيف ص 48].
والإرب بالكسر أيضا: العضو المخصوص، ومنه: «السجود على سبعة آراب». [المجمع 2/ 124]. فيجوز أن يكون هو المراد في الحديث: «فإنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان أملك لإربة منكم». [أخرجه البخاري في (الحيض) (5)، ومسلم في (الحيض) (2)] فإنّ القبلة داعية إلى تحرك العضو وطلب الجماع، فهو- عليه الصلاة والسلام- كان قادرا على أن يرد نفسه ويقهرها. والإربة: البغية، وفي التنزيل العزيز: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ} [سورة النور: الآية 31]. البغية في النساء. وفي بعض الأمثال: (مأرب لا حفاوة) يضرب للرجل يتملقك، وهو لا يحبك، يراد به تملقك لحاجة لا لحب. [النهاية 1/ 35، والمصباح المنير 1/ 14، مشارق الأنوار 1/ 26، والمغني ص 252، ومعالم السنن 1/ 73، وغريب الحديث للبستي 2/ 270- 273، والمعجم الوسيط 1/ 12، 13].
والأربعاء: هو اليوم المعلوم من أيام الأسبوع بين الثلاثاء، والخميس. [طلبة الطلبة ص 308].
قال المطرزي: وهي عجلة في الكلام. وذكر الأزهري فيما أسنده عن الفراء، قال: والأرتّ: الذي يجعل اللّم ياء. وذكر صاحب (المجمل): أن الرّتّة: العجلة في الكلام والحكة فيه والحكل: ما لا نطق فيه كالنمل ونحوه. قال الشّاعر: ويقال: في لسانه حكلة: أي عجلة. وقيل: الأرتّ: أن يجعل الرّاء على طرف لسانه لاما أو يجعل الصّاد ثاء. [المغني ص 144، 145، والمعرب ص 182].
قال الجرجاني: أن يرتفق المجروح بشيء من مرافق الحياة أو يثبت له حكم من أحكام الأحياء كالأكل، والشرب، والنوم وغيرها. [المعجم الوسيط 1/ 340، والتعريفات ص 17، وموسوعة الفقه الإسلامي 4/ 249].
وارتفق به: انتفع واستعان، وارتفق عليه: اتكأ. واصطلاحا: عرّفه الحنفية: بأنه حق مقرر على عقار لمنفعة عقار لشخص آخر. عرّفه الجمهور: بأنه تحصيل منافع تتعلق بالعقار. والفرق بين التعريفين: أن الارتفاق عند الجمهور أعمّ منه عند الحنفية، لأنه يشمل انتفاع الشخص بالعقار فضلا عن انتفاع العقار بالعقار. [مشارق الأنوار 1/ 296، وموسوعة الفقه الإسلامي (المصرية) 4/ 274، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 43].
وفي الحديث: «فإنّكم على إرث هو من إرث إبراهيم». [أخرجه النسائي في (المناسك) (202)] أي: إنكم على بقية من شرعه، وأمره القديم. [مشارق الأنوار 1/ 26، والمعجم الكبير 1/ 183، وطلبة الطلبة ص 149].
وأصل الرحم: رحم المرأة، وهو موضع تكوين الولد، ثمَّ أستعير للقرابة. [المفردات ص 191، والمصباح المنير ص 223 (علمية)، ومشارق الأنوار 1/ 286].
[التوقيف ص 50].
ويقال: أصله: هرش، وهو اسم للمال الواجب على ما دون النفس. وقد يطلق ويراد به: دية النفس. [المصباح المنير مادة (أرش) ص 12، وطلبة الطلبة ص 330، والتوقيف ص 50، والكليات ص 78، والتعريفات ص 17].
ويطلق لفظ (الإرشاد) على التبيين، ولا يلزم التبيين الإصلاح، في حين أن الإصلاح يتضمن حصول الصلاح. [المغرب ص 189، والموسوعة الفقهية 5/ 62].
قال العكبري: مشتقة من أرضت القرحة: أي اتسعت، فسمّيت به لاتساعها، وجمعها: أرضون، ولم تجمع في القرآن لثقله. وتجمع على: الأراضي، والأروض كذا في (المصباح). قال الحرّالى: الأرض: المحلّ الجامع لنبات كلّ نابت ظاهر أو باطن، فالظّاهر كالمواليد وكل ما الماء أصله، والباطن كالأعمال والأخلاق. [المفردات ص 16، والمصباح المنير ص 12، والكليات ص 73- 77، والتوقيف ص 51].
وسمّيت بذلك، لأن الإمام حازها لبيت المال ولم يقسّمها. [الموسوعة الفقهية 3/ 119].
ومنه: (أيّ مال اقتسم وأرّف عليه فلا شفعة فيه): أي حدّ وأعلم. [النهاية 1/ 39، والمغني ص 384].
قال أبو زيد: أزم علينا الدّهر: إذا اشتدّ أمره وقلّ مطره وخيره. [النهاية 1/ 46، والمغني ص 27].
وإساءة: أفسده، وأسوت بين القوم: أصلحت. ويقال: آسى أخاه بنفسه وبماله، والإساءة منقولة عن ساء. [الكليات ص 114]. |